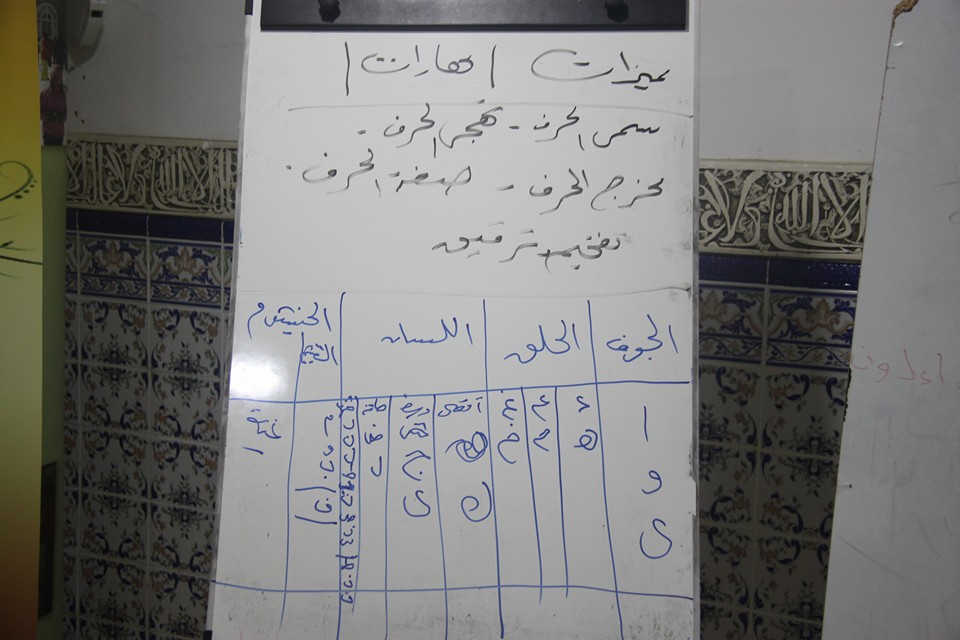فلسفة الإسلام في التعايش مع الآخر
يؤسس القرآن الكريم لفلسفة إسلامية متميزة في رؤية الكون والحياة والعلاقات بين الأحياء. وفي هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة معالم رئيسية، يمكن أن نشير إلى عدد منها:
أ- أن الواحدية والأحدية هي فقط للذات الإلهية.(1)
بـ- وأن التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف هو سنة إلهية كونية مطردة في سائر عوالم المخلوقات. وأن هذه التعددية هي في إطار وحدة الأصل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسانية التي خلقها الله من نفس واحدة تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان. وكذلك إلى شرائع في إطار الدين الواحد. وإلى مناهج، أي ثقافات وحضارات في إطار المشترك الإنساني الواحد، الذي لا تختلف فيه الثقافات. كما تتنوع إلى عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حتى داخل الحضارة الواحدة، بل والثقافة الواحدة.
وهذا التنوع والاختلاف والتمايز يتجاوز كونه “حقّا” من حقوق الإنسان، إلى حيث هو “سنة” من سنن الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾(النساء:1).. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾(هود:118-119). وكما يقول المفسرون: “فللاختلاف خلقهم”.
فالواحدية والأحدية فقط للحق سبحانه.. والتنوع هو السنة والقانون في كل عوالم المخلوقات.
جـ- وأن هذا التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف له مقاصد عديدة، منها: تحقيق حوافز التسابق على طريق الخيرات بين الفرقاء المتمايزين: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (المائدة:48). ومنها: فتح أبواب الحرية للاجتهاد والتجديد والإبداع، الذي يستحيل تحقيقه دون تفرد وتمايز واختلاف: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾(البقرة:148).
د- وأن علاقة الفرقاء المتمايزين والمختلفين والمتعددين يجب أن تظل في إطار الجوامع الموَحِّدة، وعند مستوى التوازن والعدل والوسطية: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾(البقرة:143). “فالوسط” -بنص الحديث النبوي- هو “العدل” الذي يجب أن يحكم علاقات الفرقاء المختلفين،” (رواه الإمام أحمد).
هـ- فإذا اختلت موازين العدل والوسط بين الفرقاء المختلفين والمتمايزين في الطبقات الاجتماعية أو الشرائع الدينية أو الفلسفات أو الحضارات، فإن الفلسفة الإسلامية تحبذ طريق “التدافع” الذي هو حراك يُعَدّل المواقف والمواقع والاتجاهات، فينتقل بها من مستوى الخلل والظلم والجور والعدوان إلى مستوى العدل والتوازن والوسط والتعايش والتعارف، مع المحافظة على بقاء التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾(فصلت:34).
وهذا “التدافع” الذي هو وسط بين تفريط “السكون والموات” وبين إفراط “الصراع”، هو المزكي للتعددية، وللتنافس والتسابق على طريق الخيرات، بينما السكون يفضي إلى الموات للمستضعفين. كما أن الصراع يفضي إلى نفس النتيجة؛ لأن القوي يصرع الضعيف، فينفرد بالساحة، وينهي التعدد والتمايز والاختلاف. فالتدافع هو الذي يُعَدِّل المواقف الظالمة، مع الحفاظ على التعددية وعلى التنافس والتسابق على طريق الخيرات. فهو سبيل للإصلاح في ظل التنوع والتعدد، وليس على أنقاض التنوع والتعدد: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾(البقرة:251).(2)
هذا هو موقع التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف في الرؤية الإسلامية للكون والحياة والعلاقات بين عوالم المخلوقات والأفكار، ودور هذا التنوع في التقدم والإصلاح.
وذلك هو تميز الفلسفة الإسلامية بالوسطية الجامعة عن غيرها من نزعاتِ وفلسفات الدمج القسري للكل في واحد.. أو نزعات وفلسفات الصراع التي تفضى هي الأخرى إلى انفراد طرف واحد -هو الأقوى- بالساحة والامتيازات. فطرَفا الغلو يفضى كل منهما إلى ذات النهاية.. وبينهما تتميز الوسطية الإسلامية في هذا الميدان..
مع الآخرالديني
وفي دولة النبوة بالمدينة المنورة سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن جسّدت فلسفة الإسلام في العلاقة بالآخر الديني؛ الكتابي منه والوضعي: اليهود والنصارى، والمجوس ومن ماثلهم.. ولقد صيغت هذه السنن النبوية، المعبرة عن هذه الفلسفة الإسلامية، في وثائق دستورية، طبّقتها دولة النبوة، ورعتها دولة الخلافة الراشدة، وظلت مبادئها مرعية إلى حد كبير عبر تاريخ الحضارة الإسلامية وأوطان عالم الإسلام.
1-مع الآخر اليهودي
وأُولى هذه الوثائق الدستورية هي “الصحيفة، الكتاب”، دستور دولة المدينة المنورة، الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الهجرة، وفور إقامة “الدولة” ليحدد حدود الدولة، ومكونات رعيتها (الأمة)، والحقوق والواجبات لوحدات الرعية، بمن فيهم الآخر الديني (اليهود العرب وحلفاؤهم العبرانيون)، وليحدد كذلك المرجعية الحاكمة للدولة ورعيتها.
وفي هذه الوثيقة الدستورية تحدثت موادها -التي زادت على الخمسين مادة- عن التنوع الديني في إطار الأمة الوليدة والدولة الجديدة، وعن المساواة بين الفرقاء المتنوعين، فقالت عن العلاقة بين المسلمين واليهود، أي عن التنوع الديني في إطار وحدة الأمة: “..ويهودُ أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ -“يُهلك”- إلا نفسه وأهل بيته، ومن تبعنا من يهود فإن له النصر والأُسوة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة، غير مظلومين ولا مُتَنَاصَرٍ عليهم، ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم..” (3)
فكانت هذه الوثيقة الدستورية أول “عقد اجتماعي وسياسي وديني” -حقيقي وليس مفترضاً ومتوهما- لا يكتفي بالاعتراف بالآخر، وإنما يجعل الآخر جزءً من الرعية والأمة والدولة -أي جزءً من الذات- له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات، وذلك في زمن لم يكن فيه طرف يعترف بالآخر على وجه التعميم والإطلاق.
2-مع الآخر النصراني
أما الوثيقة الدستورية الثانية، فهي خاصة بالعلاقة مع الآخر النصراني، وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران -عهداً لهم ولكل المتدينين بالنصرانية عبر المكان والزمان- وذلك عند أول علاقة بين الدولة الإسلامية وبين المتدينين بالنصرانية. وفي هذا العهد الدستوري كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لنجران وحاشيتها، وسائر من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض جوار الله، وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.. أَن أحمى جانبهم وأذبّ عنهم وعن كنائسهم وبيَعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح، وأن أحرس دينهم وملّتهم أين ما كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصّتي وأهل الإسلام من ملتي؛ لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم”(4)
فبلغت هذه الوثيقة في الاعتراف بالآخر الديني، والقبول به، والتكريم له، والتمكين لخصوصياته، والاندماج معه، مالم تبلغه وثيقة أخرى عبر تاريخ الإنسانية، مع ميزة كبرى، وهي جعلها لهذا التنوع والاختلاف في إطار وحدة الأمة، تجسيدًا لفلسفة الدين الإسلامي في العلاقة بالآخر، وليس على أنقاض الدين كل دين.
3-مع الآخر أهل الديانات الوضعية
أما السنة النبوية الثالثة التي قننت للعلاقة بالآخر الديني، فلقد مدّت نطاق الآخر إلى أهل الديانات الوضعية؛ فعاملتهم معاملة أهل الديانات الكتابية. ولقد بدأ تطبيق دولة الخلافة الراشدة لهذه السنة عندما دخل المتدينون بالمجوسية في إطار الرعية الواحدة لدولة الخلافة الراشدة على عهد الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلقد عرض عمر رضي الله عنه هذا الواقع الجديد على مجلس الشورى (مجلس السبعين)، وسأل: “كيف أصنع بالمجوس؟” فوثب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: “أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “سُنّوا فيهم سنة أهل الكتاب”.(5)
التواترات الدينية استثناء من السنة النبوية
منذ القرن الهجري الأول ضمت الدولة الإسلامية أوطاناً ودياراً وأقاليم، كما ضمّت شعوبًا وقبائل وديانات وفلسفات ومذاهب جسدت كل ألوان وأطياف التنوع والاختلاف الذي عرفه الإنسان في ذلك التاريخ.
ولقد تعاقب على حكم الخلافة الإسلامية، والدول التي تفرعت عنها وورثت سلطانها ألوان من الخلفاء والسلاطين والولاة، منهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم العادل ومنهم الجائر، ومنهم الذي جمع بين المتناقضات.
ولا يتصور عاقل أن تاريخًا بهذا الطول (قرابة خمسة عشر قرنًا) لأمة بهذا التنوع، وعالم بهذا الاتساع، وفي ظل تحديات خارجية شرسة، يمكن أن يخلو من التوترات الدينية بين الفرقاء الذين عاشوا على أرض الإسلام. لكن النظر إلى هذه التوترات الدينية التي تمثل خروجًا عن السنة النبوية التي تقررت منذ دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة يجب أن يكون في حجمها الحقيقي، وفي إطار مقارنتها بما كانت عليه الحضارات الأخرى، كما حدث بين البروتستانت والكاثوليك في الحروب الدينية الأوروبية التي دامت أكثر من قرنين، وأبيد 40 % من شعوب وسط أوروبا، والحروب بين البيض والسود في أمريكا.. وفوق ذلك ومعه، يجب النظر إلى هذه التوترات الدينية والطائفية في إطار الأسباب الحقيقية التي ولّدت وقائعها وأحداثها.
ولعل شهادة العلماء والباحثين غير المسلمين أن تكون خير شاهد من أهلها على حقيقة حجم هذه التوترات وأسبابها:
فالعالم الإنجليزي الحجة “سير توماس أرنولد” يشهد للحرية الدينية التي قرّرها الإسلام وحضارته، والتي وسعت التنوع والاختلاف، وأتاحت إنقاذ النصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية البيزنطية، حتى ليمكن القول: إن بقاء النصرانية الشرقية هو “هبة الإسلام”.(6)
والعالم الألماني الحجة “آدم متز” يتحدث عن دور غير المسلمين في إدارة دواوين الدولة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي، فيقول: “لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام”.(7)
أما الباحث والمؤرخ المسيحي اللبناني “جورج قرم”، فإنه يرجع التوترات الدينية والطائفية -العابرة والمحدودة- التي شهدها التاريخ الإسلامي إلى عوامل ثلاثة، هي: 1-المزاج الشاذ لبعض الحكام الشواذ الذين حكموا بعض البلاد الإسلامية لبعض الوقت والذين اضطهدوا الأقليات كجزء من اضطهادهم العام للرعية كلها. 2-صلف الوزراء والجباة والقادة غير المسلمين، واستعلاؤهم على جمهور المسلمين، وثراؤهم المستفز، وظلمهم واضطهادهم لعامة الفقراء المسلمين؛ الأمر الذي ولّد ردود أفعال طائفية لم تقف عند الذين ظُلموا من أبناء هذه الأقليات خاصة، وإنما عمت البلوى جماهير الأقليات. 3-غواية الاستعمار الأجنبي-الصليبي والإنجليزي والفرنسي- لقطاعات من أبناء الأقليات، كي تمالئ الغزاة، وتخون أمتها ووطنها، ونجاح هذه الغوايات الاستعمارية في كثير من الأحيان، الأمر الذي ولّد ردود أفعال عنيفة ضد أبناء هذه الأقليات التي وقعت في شباك الغوايات.(8)
هذا هو حجم التوترات الدينية في التاريخ الإسلامي.. وتلك هي أسباب هذه التوترات، كما شهد بها المنصفون من العلماء والباحثين غير المسلمين.(9)
العلاقة مع الآخر الثقافي
في الموقف من الثقافات التي تنتشر على النطاق العالمي، وفي إطار الحضارات غير الإسلامية، هناك مواقف ثلاثة، لكل واحد منها أنصار ومحبذون:
وأول هذه المواقف هو موقف المثقف “خالي الشغل”، ذلك الذي يمثل عقله صفحة بيضاء خالية من الموقف والخصوصية والذاتية الحضارية، وتنطبع عليها كل ألوان الوافد والمستورد، حتى لكأن عقله هذا مكتب من مكاتب الاستيراد، التي تعيش بها وعليها طبقة “الكومبرادور” الطفَيلية، التي لا علاقة لها بالإنتاج الوطني والقومي، ولا علاقة لعقولها بالإبداع الفكري والثقافي والحضاري.
وثاني هذه المواقف هو موقف الانغلاق دون الثقافات العالمية جميعها، وتحريم الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في الحفاظ على لغاتها وآدابها وفنونها وثقافاتها، وفي التطوير لهذه الثقافات، والتجريم لكل ألوان الانفتاح على هذه الثقافات.
وأصحاب هذا الموقف يحلمون بـ”المستحيل – الضار”.. فما يريدونه مستحيل التحقيق، لأن بناء أسوار صينية بين الثقافات العالمية لم يتحقق قديمًا، فما بالنا به في عصر ثورة وسائل الاتصال؟!
وهذا المستحيل ضار -على فرض إمكان تحققه- لأن الانغلاق الثقافي يؤدي بأصحابه إلى مثل ما يؤدي إليه الإضراب عن الطعام والشراب بجسم الإنسان، حيث يتغذى الجسم على ذاته، فيستهلك هذه الذات، ويصاب بالذبول والضمور والاضمحلال.
وإذا كانت التبعية الثقافية تؤدّي بأصحابها إلى التقليد الذي يذيب التميز، فتضمحل به الذاتية والخصوصية، فإن الانغلاق يقود -هو الآخر- إلى ذات النتيجة البائسة والمأساوية.. فكلا التفريط والإفراط يفضيان إلى مأساة الذبول والاضمحلال للشخصية الوطنية والقومية في الثقافة والحضارة.
موقف التفاعل المتوازن
أما الموقف الثالث من الثقافات العالمية، فهو الوسط العدل الذي يختار طريق “التفاعل” مع الحضارات والثقافات العالمية، من موقع الراشد المستقل، دونما إفراط في الخصوصية يؤدي إلى “الانغلاق” أو تفريط يؤدي إلى “التبعية” والتقليد والذوبان.
وهذا التفاعل مع الثقافات العالمية هو الذي يميّز بين خصوصيتنا الثقافية المتمثلة في منظومة القيم الإسلامية، التي هي معايير القبول والرفض لما لدى الآخرين، وبين ما هو مشترك إنساني عام، سواء أكان هذا المشترك علومًا طبيعية ودقيقة ومحايدة، أو تطبيقات لهذه العلوم في التقنيات التي يتم بها عمران الواقع المادي في المجتمعات الإسلامية، أو كان هذا المشترك الإنساني العام خبرات وتحارب إنسانية في ميادين ترقية الثقافة واللغة وتطعيم ثقافتنا وإثرائها بالقوالب المستحدثة والنافعة في الفضاءات الثقافية الأخرى.
فهذا الموقف الثالث -موقف التفاعل الخلاق بين الثقافات والحضارات- هو النافع… وهو الوسط العدل بين غلوّ الإفراط والتفريط في الانغلاق والعزلة وفي التبعية والتقليد.
بل إن هذا الموقف الثالث (الوسطي والمتوازن والعادل) يكاد يكون هو القانون العادل الذي حكم العلاقات الصحية والناضجة بين الثقافات والحضارات على مر التاريخ.
فالمسلمون عندما انفتحوا على ثقافة مدرسة الإسكندرية في القرن الهجري الأول، ترجموا علوم الصنعة (تقنيات العلوم الطبيعية والدقيقة والمحايدة) ولم يترجموا ديانات مصر (الوثنية أو النصرانية) ولا الفلسفات الهلينية والغنوصية. وكذلك صنع المسلمون عندما انفتحوا على التراث الروماني، منذ عصر الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقد أخذوا نظم الدواوين، دون أن يأخذوا القانون الروماني. وكذلك كان الحال في التفاعل الإسلامي مع الحضارة الفارسية؛ فلقد أخذ المسلمون تجارب الفرس في التراتيب الإدارية، دون أن يأخذوا فلسفات المجوسية وعقائدها الدينية. وبنفس المعايير كان الانفتاح والتفاعل الإسلامي مع المواريث الهندية؛ إذ أخذ المسلمون فلك الهند وحسابها، دون أن يأخذوا فلسفتها وديانتها. ولقد حكمت ذات المعايير الانفتاح الكبير للحضارة الإسلامية على التراث الإغريقي؛ فأخذوا من الإغريق العلوم الطبيعية والتجريبية، دون أن يأخذوا وثنية الإغريق. وبنفس المعايير كان انفتاح الحضارة الأوروبية -إبان نهضتها- على الحضارة الإسلامية، عندما أخذت العلوم التجريبية والمنهج التجريـبي، والخبرات الإسلامية، دون منظومة القيم الإسلامية، والعقائد الإسلامية، وفلسفة العلم عند المسلمين.
إن الخصوصية الثقافية هي الضرورة المحركة للعقل المسلم كي يبدع ويجدد؛ بينما الانغلاق والتبعية والتقليد تفضي إلى الذبول والذوبان والاضمحلال.
لقد تميزت فلسفة الإسلام في النظر إلى الشرائع والملل والنحل الدينية غير الإسلامية، وفي العلاقة بالمتدينين بتلك الشرائع والملل والنحل بالموقف الوسطي الذي قرر أن دين الله واحد، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشرائع السماوية متعددة بتعدد أمم النبوات والرسالات في إطار وحدة عقائد هذا الدين الإلهي الواحد. فتحققت بهذه الفلسفة الوحدةُ الدينيةُ مع التمايز في الشرائع الدينية أيضًا.
وبهذه الفلسفة الإسلامية في النظرة للآخر الديني حقق الإسلام “ثورة إصلاحية.. وإصلاحًا ثوريًّا” تجاوز الاعتراف بالآخر والقبول به والتمكين له، إلى حيث جعل هذا “الآخر في الشريعة” جزءً من “الذات الدينية الواحدة”، وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات بين أبناء الديانات والحضارات.
ووحده الإسلامُ هو الذي بدأت به مسيرة جعل الآخر جزءً من الذات الدينية؛ فقرر للآخَرين ذات الحقوق وذات الواجبات في الدولة والأمة: “لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم..”.
بل لقد جعل الإسلام من الآخر الديني جزءً من أولي الأرحام عندما أقام الأسرة -وليس فقط الأمة- على التنوع الديني. فأصبحت الزوجة الكتابية سكَنا يسكن إليها المسلم، وموضع محبته ومودته، بينهما ميثاق الفطرة.. حتى لكأنهما ذات واحدة يجمعها لباس واحد: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (البقرة:187).(10)
ولأن فلسفة الإسلام وهي تتطلع إلى المثالي، لا تغفل عن مكنونات “الواقع” تميزت بالعدل الذي لا يضع كل أهل الكتاب في سلّة واحدة وصنف واحد، بينما ميّزت بين فرقائهم بحسب موقف كل فريق من “الكلمة السواء”، التي هي التمايز في الشرائع بإطار وحدة الدين: “الأنبياء أبناء علاّت، دينهم واحد، وأمهاتهم شتّى” (متفق عليه). ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران:64).
فأهل الكتاب ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾(آل عمران: 113-115).
وليس من العدل أبدًا التسوية بين هؤلاء الذين تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، وبين الذين دخلوا في لون من الشرك والكفر: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾(المائدة:72).
لكن الإسلام مع هذا التمييز بين فرقاء أهل الكتاب، والعدل في التمييز بين مواقفهم من “الكلمة السواء”، قد جعل حساب كل ذلك إلى الله وحده يوم الدين. أما في الدنيا والدولة والتكريم الإلهي لمطلق بني آدم، فقد قرر الإسلام لكل هؤلاء الفرقاء ذات الحقوق وذات الواجبات التي قررها للمسلمين المؤمنين بكل الكتب وكل النبوات والرسالات.. وبنص عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران وكل من ينتحل دعوة النصرانية: “فإن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم”.
تلك هي مرتكزات التعايش مع الأديان الأخرى، في القرآن الكريم، وفي التطبيق النبوي لهذا القرآن الكريم..
بقلم : أ.د. محمد عمارة
______________
الهوامش
(1)انظر: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾(الإخلاص:1-4).
(2)وانظر: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا..﴾(الحج:40).
(3)مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، لمحمد حميد الله، القاهرة 1956 م، ص15-21.
(4)مجموعة الوثائق السياسية، لمحمد حميد الله، ص123-128.
(5)فتوح البلدان، للبلاذري، القاهرة 1956م، ص 327.
(6) الدعوة إلى الإسلام، سير توماس أرنولد، القاهرة 1970، ص 729-730.
(7)الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم متز، بيروت 1967م، 1/105.
(8)تعدد الأديان وأنطمة الحكم، جورج قرم، بيروت 1979م، ص 211-224.
(9)انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي (766-845هـ)؛ عجائب الآثار، للجبرتي (1167-1237هـ).
(10)وانظر: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾(النساء:21).