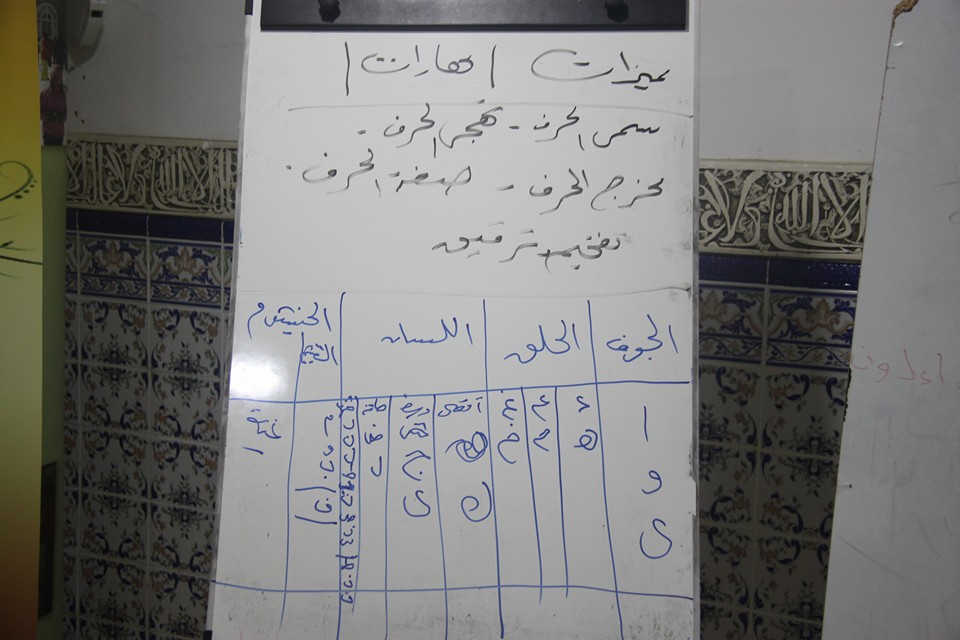الوَسَـطِيَّةُ والبُعْـدُ الحَضـارِيُّ
د/ أحمـد الراوي
في هــذه الورقــة:
- مدخـل:
في الوسطية وبُعدها الحضاري
- المبحث الأول:
في علاقة الحضارة والثقافة الإسلامية بالحضارات والثقافات الأخرى
- المبحث الثاني:
الابتعاد عن هيمنة حضارة وثقافة واحدة على بقية الحضارات والثقافات
- المبحث الثالث:
ظروف ومتغيرات ومستجدات تحث على بلورة المشروع الحضاري الإسلامي
- المبحث الرابع:
من معالم المشروع الحضاري الإسلامي المنشود
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَكَذلكَ جَعَلْناكُم أمّةً وَسَطاً لِتَكونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسولُ عَلَيكُم شهيداً) البقرة 143
مدخـل:
في الوسطية وبُعدها الحضاري
إنّ الوسَطيّةَ كمفهومٍ نحمِلُه؛ نراهُ بديلاً عن منزلقِ الإفراط وهاويةِ التفريط. إنها دلالةٌ على طابع التوازن والتكامل والانسجام، الذي نستقيهِ من فهمِ الإسلام واستلهامِ توجيهاتِه.
وباعتمادِ الوسَطيّةِ في الرؤيةِ والفكرِ والمعالجة؛ ينبغي أن يتداعي أهلُ العلم والفكر والرأي للرد على محاولات تفريغ الإسلام من محتواه، وتعطيل رسالته أو تشويهها، كما ينبغي لهم بالمقابل التصدِّي لنزعات التشدِّد والتطرّف والغلوّ، وهي التي ساهمت هي الأخرى، وعلى نحوٍ وافرٍ، في تشويه فهمِ الإسلام وصورَتِه، وكان لها دورُها الملموسُ في التعمية على صورة الإسلام النقيّة.
وإنّنا انطلاقاً من الفهم الوسطيِّ؛ نرى في تشجيع حوار الحضارات والثقافات؛ الخيار الأفضل الذي يجب أن تتجه إليه جهود المسلمين وغيرهم، بدل خيار الصدام الذي لا يمكن أن يكون في مصلحة أحد.
ومن هنا؛ جاءت هذه الورقةُ لتتناول جوانبَ متصلةً بالبُعدِ الحضاريِّ للوسطية. فهي تتطرقُ إلى علاقةِ الحضارةِ والثقافةِ الإسلاميّة بالحضارات والثقافات الأخرى. فالحضاراتُ تجمعها علاقةٌ تفاعليةٌ، تقوم على التبادل والتكامل، وينطبق هذا على الحضارة الإسلامية كما ينطبق على غيرها، ولكنّ الحضارة الإسلامية بصفة خاصة تقوم على إدراك صفةِ التنوّعِ البشريِّ، وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع ما يستتبِعُهُ من تنوّعٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ، فهي لا تعترفُ بذلك وحسب؛ بل وتعدّه معه مكسباً جماعيّاً.
كما تحذِّر الورقة من هيمنة حضارة وثقافة واحدة على بقية الحضارات والثقافات، فلا ريب أنّ أحد الاشتراطات التي ينبغي تحقيقها في واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات؛ يتمثل في السعي إلى تحقيق حالة التكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة، ويُقصد بذلك أن تكونَ العلاقةُ التفاعليةُ بين الحضاراتِ والثقافاتِ قائمةً على مبدأ الندِّيّة، وهي حالةٌ لا يتمُّ معها الشعورُ باستعلاءِ طرفٍ حضاريٍّ على الآخر، أو بهيمنةِ حضارةٍ على الحضاراتِ الأخرى.
وتبحث الورقةُ كذلك ظروفاً ومتغيراتٍ ومستجداتٍ تحثّ بدورها على بلورة المشروع الحضاري الإسلامي.
فإذا كان المسلمون قد عاشوا قروناً من الضمور الحضاري الذي لا ينبغي له أن يستمرّ أو يتواصل، فإنه يتوجّب استئناف النهضةِ الحضاريةِ الإسلاميةِ من جديد، وهو ما تحثّ عليه أيضاً جملة من الظروفِ والمتغيراتِ والمستجدات، والتي تؤكد في مجموعها أهميةَ بِلْوَرة المشروع الحضاري الإسلامي المنشود، والذي ينبغي في الأصل أن يأتي اتساقاً مع رسالة الإسلام السامية وتوجيهاته الحضارية.
ومن ثم؛ تقف بنا الورقةُ عند هذا المشروع الحضاريِّ الإسلاميِّ المنشودِ للمرحلة المقبلة، ساعية إلى أن تُضيءَ بعضَ معالِمِه وأن تُركِّزَ على عددٍ من مفاصِلِه.
المبحث الأول:
في علاقة الحضارة والثقافة الإسلامية بالحضارات والثقافات الأخرى:
تجمعُ الحضاراتِ علاقةٌ تفاعليةٌ، تقوم على التبادل والتكامل، وبهذا فإنّ الحوار بين الحضارات ليس ظاهرة جديدة، بل هو لازم للحضارة لا انفصامَ لها عنه، خاصة وأنّ الحضارة الواحدة تتنفس من فضاء الحضارات الأخرى.
ينطبقُ هذا على الحضارة الإسلامية انطباقَه على غيرِها، ولكنّ الحضارةَ الإسلاميّةَ بصفةٍ خاصّةٍ تقومُ على إدراك صفة التنوّع البشري وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع ما يستتبعُهُ من تنوع ثقافي وحضاري، فهي لا تعترف بذلك وحسب؛ بل وتعدّه معه مكسباً جماعياً (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) الحجرات 13، وما يصدُقُ على الفردِ يصدُقُ على المجموعِ البشريِّ، فإذا كانت “الحكمة ضالة المؤمن”؛ فإنّ عموم المسلمين، وهم الرافدُ البشريُّ الأساس للحضارة الإسلامية؛ يجدر بهم أن يدركوا أهميةَ التواصلِ من الحضارات الأخرى، والإفادةِ منها، وهو ما صدّقه التاريخُ في التجربةِ الحضارية الإسلامية السالفة.
وإذا كان من السهل تتبّع الحدود السياسية والجغرافية بين الدول والشعوب؛ فإنّ من العسير وضعَ حدودٍ جامدة للدائرة الحضارية الواحدة. فالمسلم الأوروبيُّ اليومَ مثلاً ينتمي إلى الدائرة الحضارية الإسلامية، ولكنّه في الوقت ذاته جزءٌ من الفضاء الغربي. ويحفل الواقع البشري على مرِّ التاريخ بأمثلة شبيهة، إلى الدرجة التي تجعلنا نستنتج أنّ الخارطةَ الحضارية والثقافية مفعمةٌ بالتداخلات والتقاطعات، التي هي بحد ذاتها من قنواتِ الحوار والتفاعل والتعارف بين الدوائر الحضارية، فالتنوّع سنّةٌ كونية، كما أنه مقدمة للتعارف، وفق ما يستقي المرء من المعين القرآني الذي لا ينضب.
ولعلّ هذا ما يقودنا، تلقائياً، إلى تسليط الأضواء على حقيقةٍ ماثلة أمامنا؛ وهي أنّ الحضارة الإسلامية قامت بالفعل على أرضية التواصل الحضاري، وتميّزت حقاً بهذه الخصوصية في مسيرتها. وقد كان ذلك من بين العوامل الحاسمة التي أتاحت لها فرص الاستمرار لقرون طويلة في العطاء المتجدِّد، الذي شكّل في محصلته الحافلة حلقة هامة في التاريخ الإنساني.
ورغم أنّ التاريخ البشري حافلٌ بالحروبِ الطاحنةِ بين الأمم؛ فإنّ التبادل بين الحضارات ظل قائماً على الدوام، فالحضارات تميلُ إلى التكامل في ما بينها، رغم أنّ الذين يحسبون أنهم يمسكون بزمامها قد يجنحون أحياناً نحو الصراع والتصادم لأسباب متفرقة أو لتناقض في المصالح.
ولا شك في أنّ التلاقح بين المدنيات والثقافات والحضارات هو ظاهرة ثرية وحافلة منذ فجر التاريخ الإنساني، رغم أنّ أتباع هذه المدنيات والثقافات والحضارات لا يميلون للاعتراف بحجم ما عاد عليهم من مكاسب متواصلة من خلال هذه الحالة التكاملية الباهرة، فغالباً ما يكتفون بإحصاءِ بصماتِهم التي طبعت جوانب من البيئات المدنية والثقافية والحضارية للآخرين.
وعليه؛ فلا ينبغي لتشجيع الحوار بين الحضارات أن يكون مسعىً آنياً، أو توجّهاً مؤقتاً، أو حتى مجرد ردّ فعلٍ على أطروحات الصدام بين الحضارات، أو استجابة عكسية طارئة لتطورات عالمية مثيرة للقلق، فالحوار بين الحضارات هو ترجمة لمفاهيم أصيلة، أبرزَها الإسلام، وأسّس لها في وعي المسلمين، فالحوارُ قيمة إسلامية لا مراء فيها، كما أنّ الحوارَ خاصيةٌ إنسانية، تتعزّزُ من خلالها إنسانيةُ البشر.
ولا جدال في أنّ التطورات الداهمة في السنوات الأخيرة قد وضعت مسألة العلاقة بين الحضارات على المحك، ولعلّ ما يزيد القلق في هذا الملف، أنّ أصواتاً محسوبة على الحياة الأكاديمية تحاول أن تُكسِب أطروحات القطيعة والخصام طابعاً أكاديمياً واهياً، كما تفعل ما يعزِّز ذلك أحياناً، وبكل أسف، فئاتٌ محسوبةٌ على المؤسسات ذات الصفة الدينية.
ولكن لم يغب عن انتباهنا أيضاً أنّ التطورات الملتهبة على المسرح الدولي؛ أيقظت الكثير من الجهود الرامية لتطويقِ الموقف، وتعزيز التفاهم بين الأمم، والقفز على دعوات الصراع ومحاذير الصدام.
ولا بد لنا في هذا المقام أن ندرك الدور الهام الذي اضطلع به مسلمو أوروبا، ومسلمو الغرب إجمالاً، في تشجيع الحوار بين الحضارات في هذه المرحلة الحساسة، وتفنيد حجج المنظرين لحتمية الصراع بينها، في مواقع متقدمة. فعلاوة على الجهود الحثيثة التي بُذِلت في العالم الإسلامي خلال ذلك؛ كان أن التقت جهود مسلمي الغرب ومؤسساتهم مع أصوات الحكمة والتعقل في الفضاء الغربي، لتطوِّق الحريق الذي بدى وكأنه قابل لأن يأتي على حالة التعايش والوفاق والسلم الاجتماعي في لحظة تاريخية عصيبة.
إننا في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا نرى أنّ مساعي الحوار والتلاقي والتفاهم ينبغي لها ألاّ تكون ردّ فعل آنياً، تستوجبه التطورات الداهمة. إننا ندعو، وبقوة، لأن نترجم خطاب الوفاق إلى حالةٍ متقدمة ومُستدامة من التعاونِ المثمرِ على الخيرات.
وما يجدرُ بنا أن نحذِّر منه في هذا المقام؛ خطورة الانسياق وراء مرامي الذين يحمِّلون الحضارات والثقافات، وحتى الأديان، ما لا يمكن لها أن تحتمله. فإنّ الصراع إن وُجد، والصدام إن تحقّق، ليس دليلاً على انبثاق ذلك عن إرادات ثقافية أو حضارية أو دينية، وذلك حتى مع الملاحظات التي يمكن أن نوردها على بعض المضامين الثقافية والمفاهيم المتوارثة.
فمن القسط الإقرار بأنّ الدائرة الحضارية الواحدة تنطوي هي الأخرى على قدر غزيرٍ من التنوّع والتعددية، التي هي سمة الواقع البشري أينما كان. ولذا فإنّ محاولة تنميط الكيانات الحضارية ضمن قوالب أحادية جامدة، وتجاهل ما تنطوي عليه من تفاعلات داخلية وما تشتمل عليه من التدافع الضمني؛ هو نوع من التعسّف الذي يقود حتماً إلى مغالطات في التصوّر، وتجاوزات في ما يتفرّعُ عنه من أحكام.
أجل؛ يمكن للعالم أن يشهدَ صوراً من المظالم وأشكالاً من العدوان وصراعات المصالح، ويمكن له أن يعرف أنماطاً من التعصب والتطرف والإرهاب؛ ولكنّ إلصاق هذا كلِّه تعسفاً بدين أو حضارة أو ثقافة إنما يحتاج إلى أكثر من وقفة.
المبحث الثاني:
الابتعاد عن هيمنة حضارة وثقافة واحدة على بقية الحضارات والثقافات
لا ريب أنّ العلاقة التفاعلية الإيجابية والمثمرة بين الحضارات تستدعي كل تشجيع ودعم، فالحث على الحوار بين الدوائر الحضارية والثقافية مطلب لا غنى عنه في عالمنا اليوم، ربما أكثر من أيِّ وقت مضى، ولكنّ ذلك يقتضي دراسة السبل الكفيلة بإنضاج هذه العلاقة التفاعلية والرقيّ بها، خاصة مع وجود عراقيل لا مناص من الاعتراف بها وعقبات ملموسة في سياق التفاعل الحضاري هذا.
إنّ أحد الاشتراطات التي ينبغي تحقيقها في واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات يتمثل في السعي إلى تحقيق حالة التكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة.
ولكن ما الذي نقصده بهذا التكافؤ؟
ما نقصده هنا هو أن تكونَ العلاقةُ التفاعليةُ بين الحضاراتِ والثقافاتِ قائمةً على مبدأ الندِّيّة، وهي حالةٌ لا يتمُّ معها الشعورُ باستعلاء طرفٍ حضاري على الآخر، أو بهيمنةِ حضارةٍ على الحضاراتِ الأخرى.
لا يُقصد بالتكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة؛ أن تكون هذه الأطراف جميعاً على المستوى ذاته من “الإنجاز” كمّاً وكيفاً و”الحضور” حجماً ومستوى، اللذيْن يمكن قياسهما على أرض الواقع، ذلك أنّ سنن الله في الأمم والمجتمعات وحركة التاريخ تقوم على التبادلية في الريادة وعلى التفاوت في النجاحات من أمة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، فتعرف الأمم مراحل النهوض تارةً ومراحل ضمور تارةً أخرى.
وإنما يُقصدُ بالتكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة:أن يسودَ الاعتقادُ بأنّ كافة هذه الأطراف شريكةٌ في الميراث الإنساني العام، وبوسعها أن تساهم بجدارة في صنع الحاضر والمستقبل، وأن يتمّ إدراكُ هذه الحقيقة والتعامل بمقتضاها دون إلغاءٍ أو إقصاءٍ أو تهميش.
ولا ينبغي أن يتبادرَ إلى الأذهانِ أنّ إدراكَ التكافؤ إياه هو مطلبٌ موجّهٌ إلى أطرافٍ حضاريةٍ دون أخرى، بل هي قناعةٌ ينبغي أن تتأصّل لدى جميعِ الأطراف بلا استثناء، وهي رسالةٌ موجّهة إلى “الذات” بقدر لا يقل عن توجهها إلى “الآخر”. إذ ينبغي أن يُدركَ الواقفون في مواقع الريادة العالمية، أنّهم ليسوا وحدهم في ساحة الفعل الحضاري، لا في الماضي ولا في الحاضر فضلاً عن المستقبل، وأنّ بوسع الفاعلين الحضاريين الآخرين، بارزين كانوا أم كامنين، أن يبرهنوا بشكل أو بآخر على فاعليتهم التي قد يُحسب أنها خاملةٌ أو خامدةٌ، أو حتى يُظنُّ أنها قاصرةٌ أو منعدمةٌ بالكامل. كما يُدرِكُ بموجب ذلك من يرَوْن أنفسَهم في منأى عن مواقع الريادة تلك؛ أنّهم، وبحقّ، شركاء في السياق الحضاري الإنساني العام، وأنّ لديهم مخزوناً بالوسع البرهنة على جدواه في الفعل الحضاري في الحاضر وفي المستقبل.
إنّ التواصلَ والحوارَ، والإقناعَ والمحاججة؛ إنما ينبغي أن تقوم في جملتها على مبدأ التكافؤ، بل وعلى أرضية من احترامِ الآخر المقابل وعدم التصغير من شأنه، وما أروع ما نستلهمه من المعين القرآني في مجال أدب التواصل مع المخالفين، كما نجد مثلاً في قوله تعالى: (قُل من يرزُقُكم مِنَ السماواتِ والأرضِ قُلِ الله وإنّا أو إياكُم لعلى هُدىً أو في ضَلالٍ مُبينٍ، قل لا تُسألون عمّا أجْرَمْنا ولا نُسألُ عمَّا تعمَلون)، سبأ 24-25.
وهكذا؛ فالرسالةُ إلى “الذات” تتمثل هنا تارةً في وضعِها في سياقِها الإنساني العام بما يقطع الطريق على نزوعها المُتوقّع إلى الاستعلاء، وإلغاء الآخر أو طمسه من الوعي الذاتي، وتتمثل تارةً أخرى في إدراك المقدرات الذاتية وإمكاناتها القابلة للتفعيل، بما يقطعُ الطريقَ على التهميش الاختياري للذات أو الشعور بالدونية، وبما يحرِّك أيضاً كوامنَ الفعلِ الحضاري المتألِّق.
ومن شأنِ التكافؤِ بين الأطرافِ الحضارية الفاعلةِ؛ أن يعزِّز إدراكَ واقعِ التنوّع الحضاري والثقافي في عالمنا، والتعاملَ الإيجابي مع حالة التنوّعِ هذه باعتبارها إثراءً للتجربة الإنسانية المشتركة.
ومن المؤسف أنّ مفهومَ التنوّع الثقافي قد بقي مُتَجاهَلاً، ولم يَحُز على إرهاصات الاهتمام الفعلي إلاّ في الأعوام القليلة الماضية.
فقد ساد طويلاً الانطباعُ بقصورِ الدوائرِ الحضارية غير الغربية عن الفعل والإسهام، حتى ذهبت بعض الأصوات إلى التنظير للجمود الحضاري، وتصويرِ عجلةِ الفعل الحضاري الإنساني وكأنها قد توقفت عن الدوران، بزعم أنها بلغت محطتها الأخيرة أو “نهاية التاريخ”، بحسب تعبير فرانسيس فوكوياما الذي تحدث أيضاً عن “الإنسان الأخير”. إنّ هذا الفهمَ المؤسفَ لا ينطوي على نزعةِ الاستعلاءِ الحضاريِّ المقيتةِ وحسب؛ وإنما يقومُ أيضاً على مصادرة المستقبل لحساب الحاضر، بقدر ما يعكس عدم الثقة في قدرات الأجيالِ المقبلةِ على تطوير خياراتها الحضارية.
ومن هنا؛ فإننا نباركُ مساعي المنادين باحترام التنوّع الحضاري والثقافي وحمايته وتعزيزه، ومنهم روّادٌ كثيرون في الغربِ اليومَ، ومن قبيل ذلك الجهود التي شهدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم “يونيسكو” مثلاً [1]، ونشدّ في الوقت ذاته على أيدي المحذِّرين من خطورة الأحادية الثقافية التي ترمي إلى صبغِ العالم، بحضاراته وأممه وشعوبه؛ بلونٍ واحد في حالة تعميميةٍ فاضحةٍ لا يمكن تصوّر نجاحها.
ومقابل ذلك؛ ينبغي أن ندرك أنّ أيسر السبل لتعزيز التنوّع الثقافي يتمثل في تحريكِ كوامنِ الفعلِ الحضاريِّ لدى شتى الأطراف، وأرى بصفةٍ خاصّةٍ أنّ الدائرةَ الحضاريةَ الإسلاميةَ عليها أن تقدِّم مشروعَها الحضاريَّ المتجدِّدَ للإنسانيةِ اليوم.
ولا أحسبُني مبالِغاً إذا ما ذهبتُ إلى الاستنتاج بأنّ الدائرةَ الحضارية الإسلامية بوسعها اليوم أن تستفيدَ من جملةِ الظروف والمتغيرات والمستجدات؛ في بلْوَرَةِ المشروعِ الحضاريِّ إياه وتقديمِه لذاتها وللعالم.
فما هي هذه الظروف والمتغيرات والمستجدات؟
وما هي معالم المشروع الحضاري الإسلامي الذي نقصد؟
هذا ما سنتناوله تالياً بشيء من العرض والتفصيل.
المبحث الثالث:
ظروفٌ ومتغيراتٌ ومستجداتٌ تحثّ على بلورة المشروع الحضاري الإسلامي:
ينبغي في الأصل بلورة مشروع حضاري إسلامي متجدِّد، اتساقاً مع رسالة الإسلام السامية وتوجيهاته الحضارية، وتعبيراً عن الوسطيّة وسيراً على نهجها.
ومن المؤسف أنّ المسلمين قد عاشوا قروناً من الضمور الحضاري الذي لا ينبغي له أن يستمرّ أو يتواصل، بل يتوجب استئناف النهضة الحضارية الإسلامية من جديد، وهو ما تحثّ عليه أيضاً جملة من الظروف والمتغيرات والمستجدات التي نراها في مجموعها تؤكد أهميةَ بِلْوَرة المشروع الحضاري الإسلامي المنشود.
أولاً- إرهاصات الفراغ الفكري والفلسفي:
يدخل العالم اليوم في حالة تبدو أحياناً وكأنها محكومةٌ بالفراغِ الفكريِّ والفلسفي، فإلى ما قبل عقديْن من الزمن فقط، كان التنازع والتجاذب على أشده بين قُطبيْن أيديولوجييْن أو فكرييْن، هما القطبُ الرأسمالي ذو النزعة الليبرالية من جانب، والقطب الشيوعي الاشتراكي من جانب آخر، ومن المعروف ما طرأ على الشيوعية من انحسارٍ فكري وانطفاءٍ كبير في الجذوة بشكل متزامن مع تفتّتِ النظمِ الحاكمة بهذا المذهب، التي أخفقت تباعاً، وانْهارَ مشروعُها. منذ ذلك الحين تسيّدت الرأسماليةُ الليبراليةُ الموقفَ العالميّ وباتت وفق قاعدة الفراغ والإحلال، مطروحةً على أنها الخيارُ الأوحدُ بلا منازع، ومن هنا يتضح أنّ مجرد تسيّد مذهب واحد للمشهد الإنساني العام، ورغم ما يحمل من قِيَمٍ حضاريةٍ ساهمت في بروزه كالديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك؛ فإنّ هذا الانفراد لا ينطوي على نزعةٍ أُحادية ذات تداعياتٍ مقلقةٍ وحسب؛ وإنما يكشفُ النقاب عن حجم الفراغ الهائل الذي شغله هذا المذهب بلا مزاحمةٍ تُذكر، رغم التحفظات المثارة بشأنه في عديد من الدوائر الحضارية، بما فيها الدائرةُ الحضاريةُ الغربية.
ولا يستطيع المرء أن يتجاهل ما شجّعت عليه هذه الانفرادية التي تحقّقت للمذهب الرأسمالي من تطرّف في الرؤى الفكرية والمعالجات النظرية [2] ومن تغوّل في الممارسة العملية والتجارب التطبيقية [3].
ومما يفاقمُ الإحساسَ بالفراغِ الفكري؛ تلك الأصواتُ المرتفعة التي تتحدث عن “موت الأيديولوجيات” أو ضمورها على الأقل، وسط حديثٍ عن احتكارِ المشهدِ لصالح ما يمكن تسميتُها بـ “أيديولوجية السوق”.
ثانياً- الفراغ الفكري والفلسفي بالنظر إلى المراجعات في نطاق المنظومة القيمية الغربية الحديثة:
إذا اخترنا النظرَ إلى المنظومة القِيَميّة الغربية الحديثة، باعتبارها الوعاء الفكريّ والفلسفيَ الأعمّ؛ فإننا سنلاحظ مؤشراتٍ متزايدةٍ على تنامي الشعور بحالةٍ مقبلةٍ من الفراغ الفكري والفلسفي. فهذه المنظومة التي قدّمت كثيراً من رؤاها وتصوّراتها على أنها أشبه بمُسلّمات بدت وكأنها غير قابلة للنقاش؛ ها هي تتفكّك جزئياً في بعضِ معاقلها، وما لم يكن موضعاً للتساؤل لم يَعُد كذلك.
ومن هنا يطرأُ الإحساس بأنّ المنظومة القِيَميّة الغربية الحديثة تتفكّك لحساب محاولات تفسيرية جديدة أو بفعل مراجعات “ما بعد الحداثة” ومداولاتها، ولكنّ هذه الأخيرة ليست منظومة فكرية جديدة بقدر ما هي اتجاه نقدي يمكن القول إنه يتولى نقض مسلّمات “الحداثة” وتقويض أسسها النظرية المتكرِّسة، أو كما يسميها بعضهم “استراتيجية تقويضيّة”.
ولن ننشغل في هذا المقام بمناقشة مسألتيْ “الحداثة” و”ما بعد الحداثة”؛ بل ما يعنينا في هذا السياق هو ما يمكن استنتاجُه من خلال ذلك؛ من أنّ المشهدَ الفكريّ والفلسفيّ الإنسانيّ مقبلٌ على حالةٍ من الفراغ، أو أنه على الأقل يجتاز منعطفاً كبيراً.
ومهما يكن الأمر؛ فما يمكن الاتفاقُ عليه في هذا المقامِ هو أنّ تداعياتِ المراجعاتِ الفلسفية الراهنة في الفضاء الغربي تستدعي إعمالَ النظر، وخاصة من جانب المعنيِّين ببلورة مشروعٍ حضاريٍّ إسلاميٍّ قادرٍ على طرحِ خياراتٍ إنسانية أصيلة، ولا أقول بديلة، وفق نهج تكامليّ يتعامل بشكل بنّاء مع الجوانب الإيجابية مما هو قائم اليوم فيعزِّزها، ويتولى في الوقت ذاته طرح الحلول للجوانب السلبية الملموسة.
ثالثاً – استحقاقات القناعة بالإسلام:
علاوة على ما سبق؛ فإنّ أحد تجلِّيات الفراغِ الفكريِّ والفلسفيّ تتمثلُ في واقع المسلمين، الذين يناهز عددهم المليار وثلث المليار نسمة، أي قرابة خُمس البشرية، والذين يتوزّعون على شتى قارّاتِ العالم، وبخاصةٍ في المناطقِ المتوسطة من كوكبنا. فما نَلمسُه جميعاً هو أنّ الإسلامَ هو الخيارُ المُفضّل لدى معظم المسلمين، بحمدِ الله وفضله، وقد تعزّزت القناعة بالإسلام على أنه النهجُ الأمثل وباعتباره يقدِّم الحلول أيضاً للأزمات والمشكلات المتفاقمة في الواقع المعاصر.
يمثِّل ذلك أرضيةً هامة، لكنّ البناء الفكري على هذه الأرضية يبدو لي أنه ما زال قاصراً بعض الشيء، أي أننا إزاءَ حالةٍ من الفراغ، لا بد من ملئها بالطريقة المُثلى، إذ لا يُقبل الاكتفاءُ بالعبارات العمومية دون الاكتراثِ بالتفاصيل، كما لا يصحّ الركونُ إلى معالجاتٍ فكريةٍ سطحيةٍ دون التناولِ المُعمّق ودون النفاذ إلى صميم القضايا المطروحة، ولا يجوز الاستئناس قبل ذلك وبعده بالشعارِ الذي يشير إلى أنّ “الإسلامَ هو الحلّ” دون البرنامج الذي يوضِّحُ كيفيةَ ذلك، أو الاكتفاء بإرادة الفعل دون السعي إلى التطبيق.
لقد تحققت في واقعِ المجتمعات المسلمة، بفضل الله، خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ حالةٌ متعاظمةٌ من القناعة بالإسلام كخيار وطريق. ويجدر بنا الآن أن نتساءل: وماذا بعد؟. أما آنَ أوانُ الانتقال من القناعةِ إلى استحقاقاتها، ومن الشعار إلى الممارسة، ومن الطّرحِ المُقتَضب إلى بَلْوَرةِ الرُّؤى التفصيليةِ التي بوسعها أن تنزل بالفعل إلى دنيا الناس في شتى ميادين الحياة؟.
إنّ ملءَ الفراغِ إنما يكونُ باعتماد الوسَطيّةِ في الرؤية والفكرِ والمعالجة، فيتم تحاشي الإفراط والتفريط، كما ينبغي بصفة خاصة أن يتداعى المفكرون المسلمون إلى التصدِّي لنزعات التشدد والتطرّف والغلوّ، وهي التي ساهمت في تشويه فهم الإسلام وصورته، وكان لها دورها الملموس في التعمية على صورة الإسلام النقيّة.
رابعاً – معضلاتٌ عالقة:
ما يعزِّزُ إدراكَنا لواقع الفراغ المتزايد، هو أنّ الواقع الإنساني الذي تتجدّد معه المشكلاتُ والمعضلات يشهدُ على استعصاءِ بعضِها على المعالجة أو الحلّ بالأدوات المطروحة من جانب الفاعلين الذين يتبوءون اليوم مواقعَ الريادةِ العالميّة.
ولعلنا نجدُ في معضلةِ التنمية شاهداً صارخاً على ذلك، فالتنميةُ التي تعني الكثير بالنسبة لمعظم البشرية اليوم قد أخفقت مراراً، بل وتسبّبت في تراجع إضافيّ في بعض البؤر، لأسباب لا تبتعد بنا أحياناً عن المنظومة الفكرية التي تَبَلْوَر فيها المشروعُ الإنمائي. لقد جرى الاعترافُ بهذا الإخفاق الإنمائي، لكنّ المنظومةَ الفكريةَ ذاتها ما زالت هي المرجعية رغم الشكوك التي تحوم حول قدراتها الفعلية على تقديم خيارات إنمائية صالحة لشتى المجتمعات الإنسانية.
ولنا أن نُشيرَ إلى شاهدٍ آخر، يتمثل في حصر المعالجات لبعض المعضلات بأدواتٍ محدّدة دوناً عن غيرها. فها هو فيروس نقص المناعة المكتسب / مرض الإيدز مثلاً، يتفشّى سنة وراء الأخرى، تاركاً عواقبَ كارثيةً متفاقمة، بينما يتم غضُّ الطّرْفِ عن خياراتٍ ممكنةٍ لمحاصرةِ المرَض وكبحِ جماحِهِ، وصولاً إلى تضييق الخناق عليه. لقد اعترفّ المجتمعُ الدوليُّ بالفعلِ بالعجزِ إزاء انتشار الإيدز، وهو أساساً اعترافٌ بعجزِ الأدواتِ المختارَةِ للمكافحة، لكنّ ذلك لا يعني استنفاذَ كافةِ الأدوات الممكنة، والتي يتم على المستوى العام والرسمي تحاشي الإشارة إلى بعضها لتصادمها مع بعض السلوكيات، التي تشجِّع عليها المنظومة الفلسفية التي تتبناها الأمم التي تشغل مواقع الريادة في العالم.
إنّنا نرى أنّ تعزيز قِيَمِ الإيمانِ والتديّن والفضيلةِ وحماية الأسرة والمسؤولية الذاتية؛ بوسعها أن تشكِّلَ ملامحَ خيارٍ ناجعٍ في مواجهة آفة الإيدز المُقلقة، كما ينبغي كبحَ جماحِ الجشعِ المادي الذي يمثِّل أحدَ آفات الممارسة الرأسمالية المعاصرة، وهو الجشعُ الذي يتسبّبُ، مع عوامل أخرى؛ في عدم إتاحةِ العقاقير العلاجية اللازمة لمرضى الإيدز جميعاً على قدم المساواة.
وإذا ما أمْعَنّا النظر في معضلاتٍ أخرى؛ فإنه لن يخفى علينا أنّ تجاهُلَ القيم الروحية والأخلاقية قد ساقَ الثورة العلمية إلى مزالق سحيقة، أشاعت الأحقاد والضغائن بين الأمم، كما حدث في التوظيف التدميريِّ لعلم الذرّة في سحقِ قاطني هيروشيما ونكازاكي، وكما يتجلى في ترسانة الدمار الشامل وما يرتبط بها من مخاطرَ مفزعةٍ على البشرية، وكما يمكن أن يحدث إذا ما انعَتَقت هندسةُ المورِّثات من كوابحِ القِيَمِ الروحيّةِ وضوابطِ الأخلاق.
فما الذي يُرغِمُ المتلاعبين بمنجزات العلوم الهائلة على الانضباط؛ طالما انعتَقوا من الوازع الديني والأخلاقي؟ إنّ ثمار المعرفة، عندما تسقط ناضجةً يانعةً بين أيدي الذين لا يؤمنون بالله، ولا تردعهم قيم أو تضبطهم أخلاق، ولا يقيمون اعتباراً لكرامة الإنسان؛ تكون خراباً على الأرضِ وسكانها، وهو ما ندركُ شواهدَ متضافرةً عليه في العصرِ الراهن.
إنّ ما سبق لا يعدو أن يكونَ غيضاً من فيضِ المعضلاتِ العالقة في مجتمعاتنا الإنسانية الراهنة، وهي معضلاتٌ تستدعي خياراتٍ بديلةً للحلّ، بدلاً من الركونِ إلى عمليةِ التجديدِ الشكليِّ والتحويرِ المظهريِّ للأدوات التي مُنِيَت مراراً وتكراراً بالإخفاق.
خامساً– ديناميكية جديدة للتواصل والتأثير والبلاغ:
لقد اختطفت التطوّراتُ المتلاحقةُ في عالم التقنية والاتصال والإعلام الأنظارَ منذ بدايات التسعينيات من القرن العشرين. وقد ساهمت هذه المستجداتُ الباهرة في إيجاد أرضيةٍ جديدةٍ من التواصلِ بين البشر، ومن الإحساس بالذات والقدرة على التأثير، خاصةً وأنّ هذه التطوراتِ أوجدت فرصاً غيرَ مسبوقةٍ على صعيدِ التواصل التفاعلي Interactive))، الذي لا يكتفي بالتلقِّي بل وبِوُسْعِهِ أن يبادر إلى البثّ. فاليومَ يستطيعُ أيٌّ منا، مثلاً، أن يدشِّن موقِعاً على الإنترنت يكون متاحاً لمتصفِّحي الشبكة الإلكترونية في أي مكان في العالم. لقد تطوّرت الفرص التقنية، وفي ظلالها توفرت آلياتٌ جديدةٌ بوسعها أن تكون “صوتَ من لا صوتَ لهم”. إنّ هذا التحوّل مهمٌ للغاية، خاصة وأنه يعني استحالةَ فرضِ الحصار على الفكرةِ والرأي، فضلاً عن أن يُضرَبَ حصارٌ على مشروعٍ حضاريٍّ منشودٍ ذي رؤيةٍ عالمية. وإننا نلاحظُ اليومَ على سبيلِ المثالِ لا على سبيلِ المقارنة، كيف نجحت حركةُ مناهضةِ العولمة؛ في أن تتحوّلَ إلى حركةٍ عالمية متعاظمةِ الحجمِ والأهمية والتأثير، وهو نجاحٌ لا يمكن تصوُّرُه بمعزلٍ عن الفتوح الاتصالية التي تم إحرازها في أواخر القرن العشرين.
إنّ هذه الفرص المتجددة والفعالة للتواصل والتأثير والبلاغ ينبغي أن تُستثمرَ على أفضلِ وجهٍ في إيصال خطابٍ وسطيٍّ إسلامي يتجاوز الآفاق، ويتواصلُ مع قطاعات الدائرةِ الحضاريةِ الإسلامية وشتى الدوائرِ الحضاريةِ والثقافيةِ الأخرى. ومن المؤسف أن تُستغلّ هذه الفرص لنشرِ ما يُسيءُ للصورةِ الإسلامية أو ما يسعى لطمسِ معالمها أو تشويه قسَماتِها.
سادساً – الإسلام في بؤرة الاهتمام العالمي:
يحوز الإسلام على اهتمام عالمي منقطع النظير منذ أعوامٍ عدة نجد ذلك بوضوح لدى زيارتِنا لمتاجر الكتب مثلاً في البلدان الغربية، حيث العناوين المتعلقة بالإسلام تتزاحم على أرفف الكتب الرائجة، كما نعثرُ عليه لدى التنقل بين محطات التلفزة العالمية، ونصادفه أيضاً في مواكبتنا للمجريات السياسية وللمداولات على الأصعدة الثقافية، بل إنّ الاهتمام بالإسلام اقتحم مجالات كثيرة، منها الميدان الاقتصادي كذلك على خلفية نجاح تجربة المصارفِ الإسلامية، وقبلَ ذلك كله فإنّ الإسلامَ حاضرٌ بشكلٍ بارزٍ في الميدان الديني باعتباره يُوصَف بأنه “الدين الحيّ” في عالمنا اليوم. لقد دفع ذلك بعضَهم إلى الحديثِ عن “عوْلمة الإسلام” [4] ، وهو ما يعكس بحدِّ ذاته حقيقةَ أنّ الشأن الإسلامي أصبحَ يشغلُ من الاهتمامِ والإدراك العالمييْن موقعَ القلب.
ولا جدالَ في أنّ هذه الحالة من الاهتمام الجارف لم تنشأ من فراغ، بل تسبّبت بها عوامل متشابكة، يتداخل فيها الشغف بالاطلاع مع القلق من الإسلام والمسلمين، لكنها قد تمنحُ في بعض الحالاتِ أيضاً الانطباعَ بأنّ الرأيَ العامَّ العالميَّ يرغبُ في تجديد معلوماته المسبقة عن الإسلام بعد أن تبيّن له ضحالتها أو اختلاطها بالأساطير والمعلومات الخاطئة.
وما يلفتُ انتباهَنا في هذا المقام؛ أنّ مجرد الاكتراث الكبير بالشأن الإسلامي ينطوي على بُعد إيجابي لا ينبغي تجاهله، حتى مع محاولات الإساءة والتشويه و”الإسلاموفوبيا” التي تركب موجة الاهتمام هذه. يتمثل هذا البُعد الإيجابي في أنّ الظروف تبدو مؤهلة أكثر من أي وقت مضى في العصر الحديث، للاكتراث أيضاً بمشروعٍ حضاريٍّ إسلامي يُقدّمُ إلى العالم، وهو ما يقتضي أن يتوقفَ عنده أهلُ الشأنِ من المسلمين باستشعارِ المسؤولية الخاصة والأمانة العظيمة المترتبة عليه.
المبحث الرابع:
من معالم المشروع الحضاري الإسلامي المنشود:
كم هي عظيمةٌ المسؤوليةُ الملقاةُ على عاتقِ حَمَلةِ المشروعِ الحضاريِّ الإسلاميِّ، في صياغةِ هذا المشروعِ وبلورته. ذلك المشروع الذي يقوم على ثلاثة أركانٍ قِيَمِيّة:
- منظومة القيم الروحية: التي تقوم على أساس الإيمان، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الإيمانِ والعلم، والروح والمادة، وفق ما جاء به الإسلام، في توازنٍ تتجسّدُ معه صفةُ الوسَطيّة أيّما تجسّد، آخذين بعين الاعتبار أنّ الإيغالَ في المادية هو أحد الثغرات البادية للعيان في المنظومة القيميّةِ الغربيةِ ذات الحضور الأكبر في عالمنا اليوم.
- منظومة القيم الأخلاقية: كاستشعارِ المسؤولية والعمل بمقتضاها، والوفاءِ بالأمانة، ونبذِ الغشِّ والجشعِ والكذبِ والخيانة، وتجريم الاعتداء، وصونِ الحرثِ والنّسل، وحمايةِ الأسرة، وتعزيزِ آصرةِ الزواج، والتواصلِ الإيجابي بين الأجيال، وكبحِ جماح الفساد بشتى صوره وتجلياته، وما إلى ذلك من القيم الأخلاقية.
- منظومة القيم الإنسانية الحضارية: كالمساواةِ، والعدلِ، ونَبْذِ الظلمِ، وحمايةِ كرامةِ الإنسان، وكفالةِ الحقوقِ المقرّرةِ، ومناهضَةِ الاستعلاءِ والهيمنةِ والإذلال، ومكافحة التمييزِ العنصريِّ، وغير ذلك مما هو مقرّر.
ونحن بدورنا هنا، في معرضِ تناولنا للبعدِ الحضاريِّ للوسطيّة؛ إنما نبادرُ من جانبنا بالوقوفِ عند هذا المشروع المنشودِ للمرحلة المقبلة، والتي حددناها زمنياً بالربعِ الثاني من القرن الخامس عشر الهجري، الذي دخلناه اليوم بالفعل، وقد اخترنا الوقوف عند المشروع ضمنَ ومضاتٍ نأمل معها أن نُضيءَ بعضَ معالِمِه وأن نركِّز على عددٍ من مفاصِلِه.
من معالم المشروع الحضاري الإسلامي المنشود للربع الثاني من القرن الخامس عشر الهجري:
- أنه مشروع يمثل انعكاساً لرسالة الإسلام السامية، ولمقاصده الكريمة، ولتوجيهاته العظيمة، كما هي مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
- وهو مشروع يعكس تكامل الرسالة الإسلامية، ويستوعب مختلف الأبعاد وشتى جوانب الحياة ومستجداتها، بتماسك وانسجام.
- كما أنه مشروع ينطلق من صفاء الدين الإسلامي ووضوحه، وينهل من معينه الذي لا ينضب، مراعياً في الوقتِ ذاتِه سمة التنوع والتعددية في واقعِ المسلمين وفي حياة البشر، بشتى بيئاتهم.
- ويتولى هذا المشروع التصدي للمعضلات والقضايا التي تشغل بني الإنسان ويستجيب لتحديات العصر، ولكنه لا يكتفي بذلك؛ بل ويمتلك زمام المبادرة في شتى مواقع الفعل الإنساني الحميد.
- ويكونُ هذا المشروع مُعبِّراً أصدقَ تعبيرٍ عن الإنسان، الذي كرّمه الله تعالى، ويتبنى قضاياه العادلة وهمومِه المستعصية، بغضِّ النظر عن دينِه ولونِه وعِرقِه ووطنه، فهو يبشرُ بالعدالة ويمكِّن لها، ويناهض الظلم ويتصدى له ويُعلي من شأن الحرية الحقة ويناصرها، ويؤكد المساواة بين البشر ويعزّزها، يرتفع باهتمامات البشر ويسمو بها، ويصون كرامة الإنسان ويحميها.
- ويبدي المشروعُ الحضاريُّ الإسلامي اكتراثاً بالإنسانية ككل، فلا يَقْصُر في اهتمامِهِ على أُمّةٍ دون أخرى، أو على مجالٍ دون آخر، ففي ترجمة لعالمية الإسلام على أرض الواقع؛ ينبغي لهذا المشروع أن يستوعب خصائص الأمم والشعوب في الشرق والغرب، وفي الشمال والجنوب، وأن يتسم هذا المشروع بالإحاطة لشتى القضايا والمسائل التي تشغل البشرية، من الثقافةِ إلى الاجتماع، ومن السياسةِ إلى الاقتصاد، ومن البيئةِ إلى الفن، وغير ذلك كثير.
- إنه مشروعٌ يستجمِعُ العنوانَ والمضمون، ويستوعبُ الشعار والتفصيل، لا يكتفي بالعموميات دون التفصيلات، ولا يقتصرُ على الإجمال دون الغوْصِ في أغوارِ التخصّص.
- ويتميّز هذا المشروعُ باستيعابه لحصيلة الماضي، وبتعايشِه مع الواقعِ الحاضر، وباستشرافِه لآفاقِ المستقبل، ساعياً نحو المزيد من التأثيرِ الإيجابيِّ الفاعلِ في دنيا الناس وفي حركة العصرِ والتاريخ، دون أن يتخلى في غضون ذلك كله عن مرجعيته الإسلامية الصحيحة أو توجّهاته الكبرى المقررة أصلاً.
- إنّ المشروعَ الحضاريَّ الإسلاميًّ المنشودَ يصونُ القِيَمَ والمبادئَ والأخلاقياتِ المشتركة بين الأمم والثقافات والحضارات؛ كالعدل والحرية والحقوق، ويدفع باتجاه تعزيز هذه القواسم المشتركة، والوصول إلى “كلمة سواء” في هذا الشأن. ولا بد هنا من الانتباه إلى أنّ الوصول إلى “كلمة سواء” إنما يمسّ دلالات المفاهيم أيضاً، ويقضي بالحوار حولها بشكل متكافئ، بما لا يلغي الحقَّ في التنوّعِ بشأنها أيضاً. إذ أنّ جملةٍ من المفاهيم لا يمكن لها أن تُنتَزعَ من خلفياتِها التاريخية والثقافية الخاصة بكل بيئةٍ، ليجري تعميمها قسراً على بيئاتٍ أخرى، لها ما تعتز به من الخصوصيات.
- يَتّسِم المشروعُ الحضاريُّ الإسلاميُّ بحضورِهِ في الحركة الفكرية والثقافية “المُعولَمة”، ويتميز بأنه يتضمن رؤى ومشروعات فكرية لائقة بصفتها الإسلامية ومواكبة للتفاعلات العالمية ومستجيبة للتحديات المتعاظمة على شتى الأصعدة.
- يحملُ المشروعُ الحضاريُّ الإسلامي رؤيةً لإصلاحِ النظامِ الدولي والعلاقات بين الأمم والشعوب وحكوماتها، رافضاً في ذلك شتى صور الهيمنة والاحتلال والوصاية والاستعمار.
[1] تقوم اليونسكو بمساع جديرة بالاهتمام في هذا المجال، ومن بين ما تم تحقيقه بهذا الشأن صدور الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو بالإجماع في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2002.
[2] يُمكن أن تُفهم أعمال صموئيل هنتنغتون وفرانسيس فوكوياما مثلاً في هذا السياق أيضاً.
[3] لعلّ من بينها تعاظم المخاوف من العولمة الاقتصادية وحجم الانتقادات الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسية، كما يشار في هذا الصدد إلى الاتهامات المتزايدة إلى “الليبرالية الجديدة”.
[4] Rethinking Globalization(s): From Corporate Transnationalism to Local Interventions (International Political Economy Series), by Preet S. Aulakh (Editor), Michael G. Schechter (Editor), 2000.